قازان يحصد المركز الثالث في مسابقة قاص الجامعات الأردنية عن قصته "العلمُ والطفلةُ والطوفان"
عمان جو- في احتفالية ثقافية وطنية احتضنتها جامعة الزيتونة الأردنية، تُوِّج الأديب عدنان فيصل عدنان قازان بالمركز الثالث في مسابقة "قاص الجامعات الأردنية"، التي شهدت مشاركة واسعة من ما يقارب مئة متسابق ومتسابقة من مختلف الجامعات.
وجاء تكريم الفائزين خلال احتفال رسمي برعاية معالي العين هيفاء النجار وحضور رئيس جامعة الزيتونة وعميد شؤون الطلبة، والتي أثنت معالي هيفاء النجار في كلمتها على أهمية الدور الثقافي والإبداعي الذي يؤديه الشباب في تشكيل وعي مجتمعاتهم وصياغة ملامح المستقبل.
وقد شارك قازان في المسابقة بنص قصصي حمل عنوان "العلمُ والطِفلةُ والطوفان"، وهو نصّ إنساني عميق يتناول صراع الإنسان بين الرحيل والبقاء، بين النهوض والانغمار، بأسلوب فني مؤثر ولغة شعرية متينة.
وفي حديثه عقب التتويج، عبّر قازان عن فخره بالمشاركة والفوز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس له وحده، بل هو ثمرة انتماء ورسالة، وقال:
"أهدي هذا الفوز إلى وطني الأردن العظيم، منبعه النهر ومنتهاه النخوة،
إلى كل أردني حرّ لا يزال يؤمن بالكلمة والهوية،
إلى الشباب الذين يحملون الحبر سلاحًا والخيال وطنًا ثانيًا،
إلى كل من يرى في الأدب مشروع نهضة وصوتًا لا يُكمم."
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تزرع بذور الوعي وتعزز الثقافة في أوساط الشباب، واصفًا المسابقة بأنها منصة رفيعة جمعت بين الإبداع والتعبير عن قضايا الإنسان والوطن، وأكد أن القصة كانت "صوتًا ينبض من أعماق الذات في لحظة انكسار، واستعادة، وولادة جديدة من رماد الغرق."
وقد حازت القصة الفائزة على إعجاب لجنة التحكيم والحضور، لما حملته من رمزية وطنية ودرامية تتجلى في مشهد الطفلة الغارقة والعلم الذي ينتشل البطل من التيه، في سردية تنبض بالإيمان والانتماء.
وهذه هي القصة التي فازت في مسابقة قاص الجامعات الأردنية:
العلمُ والطفلةُ والطوفان
في اللحظة التي انفجرت فيها السماء، وأخذت الأرض تتهاوى تحت المطر الجارف، كان حارث يعتقد أن القرية تلفظُ أنفاسها الأخيرة، لكنه لم يعلم أن شيئًا آخر كان يولد فيه.
كانت الريح تصرخ، والمطر يهطل بغضب، كأنَّ الغيم قرر أن يفرغ حقده دفعة واحدة، فأخفى النجوم خلف سحبه السوداء، بينما غرق الطريق الضيق المؤدي إلى المحطة الأخيرة في الظلام.. سار حارث في غِمار الوحل، وحقيبته تتأرجح على كتفه، وقلبه يخفق بتوتر، فهو لا يجرؤ على النظر خلفه، كان يهرب، يهرب من أرضٍ لم تمنحه سوى الجفاف والانتظار.
بدأ الطوفان في داخله قبل أن يجتاح أرضه، فوقف أمام منزله القديم للمرة الأخيرة، محاولًا استرجاع أي ذكرى تدفعه للبقاء، لكنه لم يجد سوى جدران متآكلة وذكريات خالية من أي شعور يُحاكيه، في عينيه سجن مُشرَع بلا قضبان، لا شيء يستحق الحنين هنا، لا شيء يدفعه للبقاء ولا الوداع، أو هكذا كان يظن.
استمر حارث بالسير حتى حلَّ بالجامع القديم، المبنى الوحيد الذي ظلَّ صامدًا في وجه الزمن، بقبَّته الرمادية التي تتخللها بعض الشقوق، ومئذنته التي تنحني قليلًا كشيخ طاعن في السن يحدِّق فيه، آيل للسقوط لكنه لا يسقط.. عند بابه، اجتمع رجال القرية يتحدثون عن المطر القادم، بينما تسلَّل صوت الشيخ العجوز، المختلط بصوت الريح، قائلًا بصوت متهدِّج: "الأرض تختبر أبناءها يا ولدي، لا يمكن لأحد أن يهرب حقًا."
كان الجامع أكثر من مجرد حجارة، كان ذاكرة القرية، ورمزيَّتها الثابتة، حيث تردَّد صدى الصلوات والمآذن منذ قرون، حيث ترعرع الأطفال في صغرهم، وحيث أُخمِدَتْ الأحزان في زواياه مع صلوات الجنازة، لكنه بالنسبة لحارث لم يكن سوى رمز من العالم الذي يريد الرحيل عنه.
ألقى نظرته الاخيرة على الجامع كما البيت قبل أن يبتعد، كأنَّ عينيه تودعان جزءًا من ماضيه الذي لم يعد يريده، لكنه لا يُبقيه ولا يُحاكيه، لم يكن يعلم أن القدر سيعيده إليهم بطريقة لا يتوقعها.
منذ طفولته، لم يشعر بالانتماء إلى هذه القرية الموحلة، حيث الحقول الجرداء والمنازل الطينية المتهاوية، لطالما اعتقد أن هذه الأرض لا تنتمي له، وأنها تبتلعه ببطء مثل مستنقع لا نهاية له، فكان يحلم بالرحيل إلى المدينة، حيث يستطيع أن يذوب في الزحام بلا هوية، بلا قيود، بلا تاريخ.. في الحين ذاته، كان يعرف في أعماقه أن هذا الهروب ليس إلا تكتيكًا مؤقتًا، فالأرض تهزّ قلبه وتشد رحاله عنه كلما ابتعد عنها، وكأنها لا تريد أن يتركها حقًا، وكأنها في انتظار عودته رغم الجفاء.
في رحيله هذا لم يكن يعلم أن الطوفان في تلك الليلة سيكشف له حقيقة ينكرُها، حقيقة أنه مهما ابتعد عن هذه الأرض فهي تسكنه كما يسكنها.
حينما وصل إلى مشارف القرية، شقت السماء صاعقة مدوية، تدفق المطر كأنَّ السماء تنزف جرحها، فما لبثَ إلا أن التفت لا إراديًا، وأبصرَ النهر الذي يمر وسط القرية يتحول إلى وحش غاضب، يبتلع البيوت وساكنيها والطُرق وعابريها، يزأر كأنه انتظر طويلًا لحظة الاقتصاص.
فالوجوه مذهولة بينما تندفع المياه بجنون، تقطع الجسور، تجرف الأبواب والنوافذ، وتلتهم الأزقة الضيقة، الأجساد تلاشت ضمن الأمواج، الأشجار اقتُلِعَتْ من جذورها بينما ثبَّتت جذوره مكانه.. تصاعدت الصرخات من كل مكان، وكان الصوت يختفي شيئًا فشيئًا في خِضَّم الطوفان، لكن بقيَ صوتًا واحدًا يُحاكيه.. رأى شيخًا يلهث وهو يحاول سحب حفيده من الماء، وامرأة تصرخ بحثًا عن طفلها الذي اغتالته الأمواج، كان الطوفان لا يرحم إنسان أو جماد أو حيوان، بقي واقفًا هناك، عالقًا ما بين البقاء والرحيل.
يتسائل عمَّا كان يرى في عينيه؟ هل كانت ذاتها القرية، التي حاول الهروب منها طوال حياته؟ هل هي تُعنيه الآن؟ هل كانت تعكس لونًا جديدًا تحت وطأة الفاجعة؟
شدَّ حقيبته بقوة وتمسَّك بها استعدادًا للرحيل، فهذا ليس من شأنه، وهذه ليست أرضه، وهؤلاء ليسوا قومه، فما الذي سيجبره على البقاء؟
حاول كثيرًا أن يخطو خطوة واحدة، لكن قدميه لم تتحركا، شيء يتشبث به ويجذبه إلى الوراء، كأن الأرض نفسها مدَّت ذراعيها، فلم يكن يستطيع الهروب، رغم محاولاته، ففي قلبه شيئًا لا يمكنه أن يهرب منه: الوطن.
حتى رآها.
فتاة صغيرة بالكاد تبلغ السابعة، متشبثة بنصف عمود خشبيّ وسط الطوفان، تصرخ بلا هدى، تمدّ يدها الصغيرة إلى الهواء وفي الفراغ، بينما يلتفّ شعرها الطويل المبلل بالعتمة حول وجهها كظلال تسحبها بعيدًا، ولا تزال تبحث عن منقذ بما تبقَّى من عينيها السوداوان اللامعة بالدموع، فتعلَّقت نظراتها بحارث وحده، لا ترى غيره صامدًا في هذا العالم الغارق.
في تلك اللحظة، لم يتبقَّ سوى الفتاة وحارث وسط هدير الطوفان، شعر بشيء يخترقه من الداخل، وكأن جدارًا ظلَّ يبنيه لسنوات طويلة بدأ في الانهيار.. فلا يعرف هذه الفتاة، وهي ليست من عائلته، لكنَّ نظراته أشعرته وكأنَّه خلاصها الوحيد.
"ساعدني…"
لم يكن صوتها سوى همسة وسط العاصفة، لكنه شعر بها بتردداتها تقصف روحه بقوة.. تردد للحظة، فبينما يعزم للرحيل، يدرك أنه إن استدار الآن فلن يغفر لنفسه أبدًا.. وفي ومضة، تحرك قلبه قبل عقله، ألقى بحقيبته، خلع معطفه، ورمى نفسه في الماء دون تفكير.
كان التيار أقوى مما توقع، وشعر بأن جسده يُغمر ويُغرق، وبأن الماء يخترق عظامه، وبأن البرد ينهش قلبه، حتى أصبح الهواء ثقيلًا، والموج يصفعه بلا رحمة، بينما عيناه معلقتين على الطفلة.
حاول أن يسبح عكس التيار، رغم الطين الذي يُوحل به للأسفل.. وأخيرًا اقترب منها رافعًا يداه حتى التقطها وأمسك بها ليرفعها فوق الماء ويشعر بذراعيها النحيلتين تلتفان حول عنقه بقوة، كأنها تتشبث بالحياة ذاتها التي يتشبث بها.
لحظة واحدة فقط، أخرجت الشعور الدفين فيه لسنوات.. هذه الأرض التي لطالما احتقرها طويلًا تطالبه بشيء واحد أخير: أن يكون ولادتها مرة أخرى.
حين أخرجها إلى اليابسة، ووضعها على الأرض الموحلة، ابتسمت له قبل أن تنهار بين ذراعي أمها، وهي تتمتم بصوت خافت:
"كنت أعرف أنه سيأتي."
تراجع خطوتين للوراء، ثم توقف.. متمعنًا في نفسه، جسده الغارق، أصابعه التي لا زالت ترتجف، روحه التي هدأت، ونبضه الذي سكن.. رفع رأسه، فرأى العلم الأردني يرفرف فوق منزل بعيد، ممزقًا بفعل الرياح والمطر، موشك على السقوط..وفي تلك اللحظة، جرَّه قلبه ثانيةً، فهو ليس مجرد علم، هو قطعة من روحه، رمزًا لأرضه التي حاول أن يهرب منها طيلة حياته، وهويته التي لم يستطع دثرها.. ودون تفكير، انطلق مسرعًا نحو العلم المتهالك، ملتقطه بسرعة قبل أن يتآكل في الطين والمياه.
أمسك به بقوة، شدَّ أطرافه الممزقة محاولاً ترميمه.. ثم رفعه عاليًا، متحديًا الريح، عائدًا للعلم شموخه، مصرًّا على أن يبقى حيًا، كأن الوطن ذاته الذي يقطنه يرفض السقوط.
شعر وهو يحمل العلم، بأنها ليست مجرد انتصار على الطوفان، بل انتصارًا داخليًا على ذاته، وتسائل في قرارة نفسه، هل كان هذا الشعور حقًا نابعًا من واجب؟ أم أنه رغبة عميقة في أن يثبت لذاته أنه لا يزال مرتبطًا بهذه الأرض، رغم كل محاولات الهروب؟
وسط هذه الفوضى والدمار، تتعلق به نظرات الناس، وبالعلم الذي عاد لرفعته، وبالرجل الذي لم يهرب.
وحين سأله أحدهم عن اسمه، قال بهدوء، بينما كانت العيون تراقب ما يجري بذهول: "اسمي حارث… وهذه أرضي."
في صباح اليوم التالي، كان قد انحسر الماء، فوجد أحدهم دفتر مذكراته، فيه جملة واحدة فقط: "في الماء، لم يكن جسدي وحده الذي يغرق، بل كل أفكاري عن الرحيل غرقتْ، حين رفعت العلم لأول مرة، شعرت كأنني انجو بذاتي من الغرق الأول."
وجاء تكريم الفائزين خلال احتفال رسمي برعاية معالي العين هيفاء النجار وحضور رئيس جامعة الزيتونة وعميد شؤون الطلبة، والتي أثنت معالي هيفاء النجار في كلمتها على أهمية الدور الثقافي والإبداعي الذي يؤديه الشباب في تشكيل وعي مجتمعاتهم وصياغة ملامح المستقبل.
وقد شارك قازان في المسابقة بنص قصصي حمل عنوان "العلمُ والطِفلةُ والطوفان"، وهو نصّ إنساني عميق يتناول صراع الإنسان بين الرحيل والبقاء، بين النهوض والانغمار، بأسلوب فني مؤثر ولغة شعرية متينة.
وفي حديثه عقب التتويج، عبّر قازان عن فخره بالمشاركة والفوز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس له وحده، بل هو ثمرة انتماء ورسالة، وقال:
"أهدي هذا الفوز إلى وطني الأردن العظيم، منبعه النهر ومنتهاه النخوة،
إلى كل أردني حرّ لا يزال يؤمن بالكلمة والهوية،
إلى الشباب الذين يحملون الحبر سلاحًا والخيال وطنًا ثانيًا،
إلى كل من يرى في الأدب مشروع نهضة وصوتًا لا يُكمم."
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تزرع بذور الوعي وتعزز الثقافة في أوساط الشباب، واصفًا المسابقة بأنها منصة رفيعة جمعت بين الإبداع والتعبير عن قضايا الإنسان والوطن، وأكد أن القصة كانت "صوتًا ينبض من أعماق الذات في لحظة انكسار، واستعادة، وولادة جديدة من رماد الغرق."
وقد حازت القصة الفائزة على إعجاب لجنة التحكيم والحضور، لما حملته من رمزية وطنية ودرامية تتجلى في مشهد الطفلة الغارقة والعلم الذي ينتشل البطل من التيه، في سردية تنبض بالإيمان والانتماء.
وهذه هي القصة التي فازت في مسابقة قاص الجامعات الأردنية:
العلمُ والطفلةُ والطوفان
في اللحظة التي انفجرت فيها السماء، وأخذت الأرض تتهاوى تحت المطر الجارف، كان حارث يعتقد أن القرية تلفظُ أنفاسها الأخيرة، لكنه لم يعلم أن شيئًا آخر كان يولد فيه.
كانت الريح تصرخ، والمطر يهطل بغضب، كأنَّ الغيم قرر أن يفرغ حقده دفعة واحدة، فأخفى النجوم خلف سحبه السوداء، بينما غرق الطريق الضيق المؤدي إلى المحطة الأخيرة في الظلام.. سار حارث في غِمار الوحل، وحقيبته تتأرجح على كتفه، وقلبه يخفق بتوتر، فهو لا يجرؤ على النظر خلفه، كان يهرب، يهرب من أرضٍ لم تمنحه سوى الجفاف والانتظار.
بدأ الطوفان في داخله قبل أن يجتاح أرضه، فوقف أمام منزله القديم للمرة الأخيرة، محاولًا استرجاع أي ذكرى تدفعه للبقاء، لكنه لم يجد سوى جدران متآكلة وذكريات خالية من أي شعور يُحاكيه، في عينيه سجن مُشرَع بلا قضبان، لا شيء يستحق الحنين هنا، لا شيء يدفعه للبقاء ولا الوداع، أو هكذا كان يظن.
استمر حارث بالسير حتى حلَّ بالجامع القديم، المبنى الوحيد الذي ظلَّ صامدًا في وجه الزمن، بقبَّته الرمادية التي تتخللها بعض الشقوق، ومئذنته التي تنحني قليلًا كشيخ طاعن في السن يحدِّق فيه، آيل للسقوط لكنه لا يسقط.. عند بابه، اجتمع رجال القرية يتحدثون عن المطر القادم، بينما تسلَّل صوت الشيخ العجوز، المختلط بصوت الريح، قائلًا بصوت متهدِّج: "الأرض تختبر أبناءها يا ولدي، لا يمكن لأحد أن يهرب حقًا."
كان الجامع أكثر من مجرد حجارة، كان ذاكرة القرية، ورمزيَّتها الثابتة، حيث تردَّد صدى الصلوات والمآذن منذ قرون، حيث ترعرع الأطفال في صغرهم، وحيث أُخمِدَتْ الأحزان في زواياه مع صلوات الجنازة، لكنه بالنسبة لحارث لم يكن سوى رمز من العالم الذي يريد الرحيل عنه.
ألقى نظرته الاخيرة على الجامع كما البيت قبل أن يبتعد، كأنَّ عينيه تودعان جزءًا من ماضيه الذي لم يعد يريده، لكنه لا يُبقيه ولا يُحاكيه، لم يكن يعلم أن القدر سيعيده إليهم بطريقة لا يتوقعها.
منذ طفولته، لم يشعر بالانتماء إلى هذه القرية الموحلة، حيث الحقول الجرداء والمنازل الطينية المتهاوية، لطالما اعتقد أن هذه الأرض لا تنتمي له، وأنها تبتلعه ببطء مثل مستنقع لا نهاية له، فكان يحلم بالرحيل إلى المدينة، حيث يستطيع أن يذوب في الزحام بلا هوية، بلا قيود، بلا تاريخ.. في الحين ذاته، كان يعرف في أعماقه أن هذا الهروب ليس إلا تكتيكًا مؤقتًا، فالأرض تهزّ قلبه وتشد رحاله عنه كلما ابتعد عنها، وكأنها لا تريد أن يتركها حقًا، وكأنها في انتظار عودته رغم الجفاء.
في رحيله هذا لم يكن يعلم أن الطوفان في تلك الليلة سيكشف له حقيقة ينكرُها، حقيقة أنه مهما ابتعد عن هذه الأرض فهي تسكنه كما يسكنها.
حينما وصل إلى مشارف القرية، شقت السماء صاعقة مدوية، تدفق المطر كأنَّ السماء تنزف جرحها، فما لبثَ إلا أن التفت لا إراديًا، وأبصرَ النهر الذي يمر وسط القرية يتحول إلى وحش غاضب، يبتلع البيوت وساكنيها والطُرق وعابريها، يزأر كأنه انتظر طويلًا لحظة الاقتصاص.
فالوجوه مذهولة بينما تندفع المياه بجنون، تقطع الجسور، تجرف الأبواب والنوافذ، وتلتهم الأزقة الضيقة، الأجساد تلاشت ضمن الأمواج، الأشجار اقتُلِعَتْ من جذورها بينما ثبَّتت جذوره مكانه.. تصاعدت الصرخات من كل مكان، وكان الصوت يختفي شيئًا فشيئًا في خِضَّم الطوفان، لكن بقيَ صوتًا واحدًا يُحاكيه.. رأى شيخًا يلهث وهو يحاول سحب حفيده من الماء، وامرأة تصرخ بحثًا عن طفلها الذي اغتالته الأمواج، كان الطوفان لا يرحم إنسان أو جماد أو حيوان، بقي واقفًا هناك، عالقًا ما بين البقاء والرحيل.
يتسائل عمَّا كان يرى في عينيه؟ هل كانت ذاتها القرية، التي حاول الهروب منها طوال حياته؟ هل هي تُعنيه الآن؟ هل كانت تعكس لونًا جديدًا تحت وطأة الفاجعة؟
شدَّ حقيبته بقوة وتمسَّك بها استعدادًا للرحيل، فهذا ليس من شأنه، وهذه ليست أرضه، وهؤلاء ليسوا قومه، فما الذي سيجبره على البقاء؟
حاول كثيرًا أن يخطو خطوة واحدة، لكن قدميه لم تتحركا، شيء يتشبث به ويجذبه إلى الوراء، كأن الأرض نفسها مدَّت ذراعيها، فلم يكن يستطيع الهروب، رغم محاولاته، ففي قلبه شيئًا لا يمكنه أن يهرب منه: الوطن.
حتى رآها.
فتاة صغيرة بالكاد تبلغ السابعة، متشبثة بنصف عمود خشبيّ وسط الطوفان، تصرخ بلا هدى، تمدّ يدها الصغيرة إلى الهواء وفي الفراغ، بينما يلتفّ شعرها الطويل المبلل بالعتمة حول وجهها كظلال تسحبها بعيدًا، ولا تزال تبحث عن منقذ بما تبقَّى من عينيها السوداوان اللامعة بالدموع، فتعلَّقت نظراتها بحارث وحده، لا ترى غيره صامدًا في هذا العالم الغارق.
في تلك اللحظة، لم يتبقَّ سوى الفتاة وحارث وسط هدير الطوفان، شعر بشيء يخترقه من الداخل، وكأن جدارًا ظلَّ يبنيه لسنوات طويلة بدأ في الانهيار.. فلا يعرف هذه الفتاة، وهي ليست من عائلته، لكنَّ نظراته أشعرته وكأنَّه خلاصها الوحيد.
"ساعدني…"
لم يكن صوتها سوى همسة وسط العاصفة، لكنه شعر بها بتردداتها تقصف روحه بقوة.. تردد للحظة، فبينما يعزم للرحيل، يدرك أنه إن استدار الآن فلن يغفر لنفسه أبدًا.. وفي ومضة، تحرك قلبه قبل عقله، ألقى بحقيبته، خلع معطفه، ورمى نفسه في الماء دون تفكير.
كان التيار أقوى مما توقع، وشعر بأن جسده يُغمر ويُغرق، وبأن الماء يخترق عظامه، وبأن البرد ينهش قلبه، حتى أصبح الهواء ثقيلًا، والموج يصفعه بلا رحمة، بينما عيناه معلقتين على الطفلة.
حاول أن يسبح عكس التيار، رغم الطين الذي يُوحل به للأسفل.. وأخيرًا اقترب منها رافعًا يداه حتى التقطها وأمسك بها ليرفعها فوق الماء ويشعر بذراعيها النحيلتين تلتفان حول عنقه بقوة، كأنها تتشبث بالحياة ذاتها التي يتشبث بها.
لحظة واحدة فقط، أخرجت الشعور الدفين فيه لسنوات.. هذه الأرض التي لطالما احتقرها طويلًا تطالبه بشيء واحد أخير: أن يكون ولادتها مرة أخرى.
حين أخرجها إلى اليابسة، ووضعها على الأرض الموحلة، ابتسمت له قبل أن تنهار بين ذراعي أمها، وهي تتمتم بصوت خافت:
"كنت أعرف أنه سيأتي."
تراجع خطوتين للوراء، ثم توقف.. متمعنًا في نفسه، جسده الغارق، أصابعه التي لا زالت ترتجف، روحه التي هدأت، ونبضه الذي سكن.. رفع رأسه، فرأى العلم الأردني يرفرف فوق منزل بعيد، ممزقًا بفعل الرياح والمطر، موشك على السقوط..وفي تلك اللحظة، جرَّه قلبه ثانيةً، فهو ليس مجرد علم، هو قطعة من روحه، رمزًا لأرضه التي حاول أن يهرب منها طيلة حياته، وهويته التي لم يستطع دثرها.. ودون تفكير، انطلق مسرعًا نحو العلم المتهالك، ملتقطه بسرعة قبل أن يتآكل في الطين والمياه.
أمسك به بقوة، شدَّ أطرافه الممزقة محاولاً ترميمه.. ثم رفعه عاليًا، متحديًا الريح، عائدًا للعلم شموخه، مصرًّا على أن يبقى حيًا، كأن الوطن ذاته الذي يقطنه يرفض السقوط.
شعر وهو يحمل العلم، بأنها ليست مجرد انتصار على الطوفان، بل انتصارًا داخليًا على ذاته، وتسائل في قرارة نفسه، هل كان هذا الشعور حقًا نابعًا من واجب؟ أم أنه رغبة عميقة في أن يثبت لذاته أنه لا يزال مرتبطًا بهذه الأرض، رغم كل محاولات الهروب؟
وسط هذه الفوضى والدمار، تتعلق به نظرات الناس، وبالعلم الذي عاد لرفعته، وبالرجل الذي لم يهرب.
وحين سأله أحدهم عن اسمه، قال بهدوء، بينما كانت العيون تراقب ما يجري بذهول: "اسمي حارث… وهذه أرضي."
في صباح اليوم التالي، كان قد انحسر الماء، فوجد أحدهم دفتر مذكراته، فيه جملة واحدة فقط: "في الماء، لم يكن جسدي وحده الذي يغرق، بل كل أفكاري عن الرحيل غرقتْ، حين رفعت العلم لأول مرة، شعرت كأنني انجو بذاتي من الغرق الأول."
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات

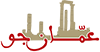


 الرد على تعليق
الرد على تعليق